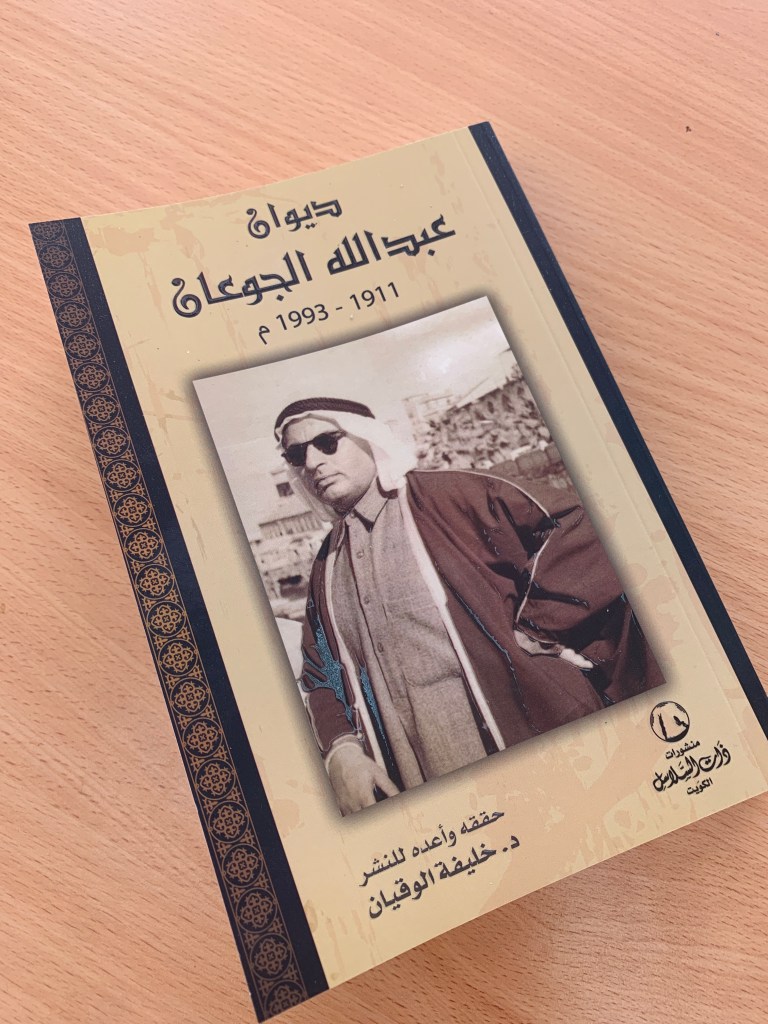قبل مطلع الألفية الثالثة، استعد العالم لدخول عصر العولمة بمزيد من الاستعداد الثقافي والتكنولوجي مع بداية قرن جديد، يختلف في تفاصيل أحداثه عن القرنين السابقين، مع عدم اختلاف عناوين القضايا الكبرى. فحتما سيشهد ثورات مختلفة في وسائلها، ولكن تتفق في أسبابها مع الثورات السابقة. لكن الثورة الجديدة والمختلفة عنوانا وتفصيلا تتمثل في عالم المعلومات والتواصل الإجتماعي، مما مكّن المجتمعات المدنية لأن تكون خارج نطاق الوصاية والقبضة الحديدة السابقة.
ولكن هل استفاد كل العالم من ذلك؟
لاشك أن الإجابة ستكون محصورة في العالم الأول وربما الثاني، حيث تجاوزت مجتمعاتها أنظمتها ودخلت في منظومة معلومات مشتركة في حالة تحديث مستمر على مستوى العلم والانتاج.
أما العالم الثالث فما يزال قابعا تحت تأثير الثقافة الاستهلاكية والتوظيف السلبي للتكنولوجيا وثورة عالم الاتصالات.
فلا نجد اختراعا أو ابتكارا هنا إلا وقد دخلت أصابع علماء الغرب في صناعته وتوجيهه وتحريكه!
على سبيل المثال المُعاش اليوم، عندما رزح العالم تحت وطأة جائحة كورونا، دخل علماء العالم الأول والثاني في صراع مع الزمن في اكتشاف لقاح لهذا الوباء القاتل، فيما انشغل معظم منظري العالم الثالث بوجود مؤامرة جديدة عليهم!
لأتساءل، كم عدد المؤامرات التي رزح تحتها العقل هنا حتى استهلكت كل فرص التفكير الإبداعي والصناعي وحل محله “التفكير” الاستهلاكي فقط؟
الاجابة باختصار، مرد هذا التفكير الاستهلاكي الشعور الدائم لإنسان اليوم بأنه مؤقت في مكان مؤقت لا يستدعي جهدا أو طموحا نحو مستقبل دائم، مادام ينتظر طابور التحديات يمر عليه وهو ساكن في مكانه.
صحيح بأن الواقع يحمل مرارة مستمرة، ولكن عندما يتجه تركيز كل منا لاصلاح عالمه الصغير وتطوره، حتما سينعكس على العالم المحيط.
فهد توفيق الهندال