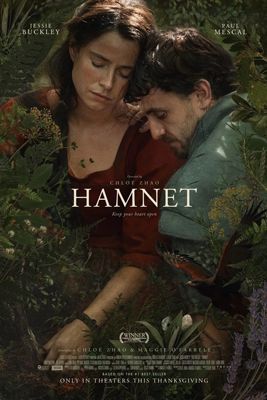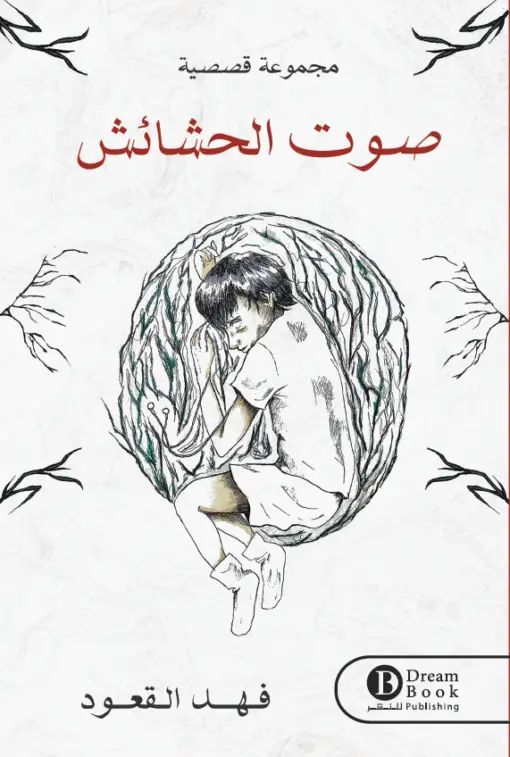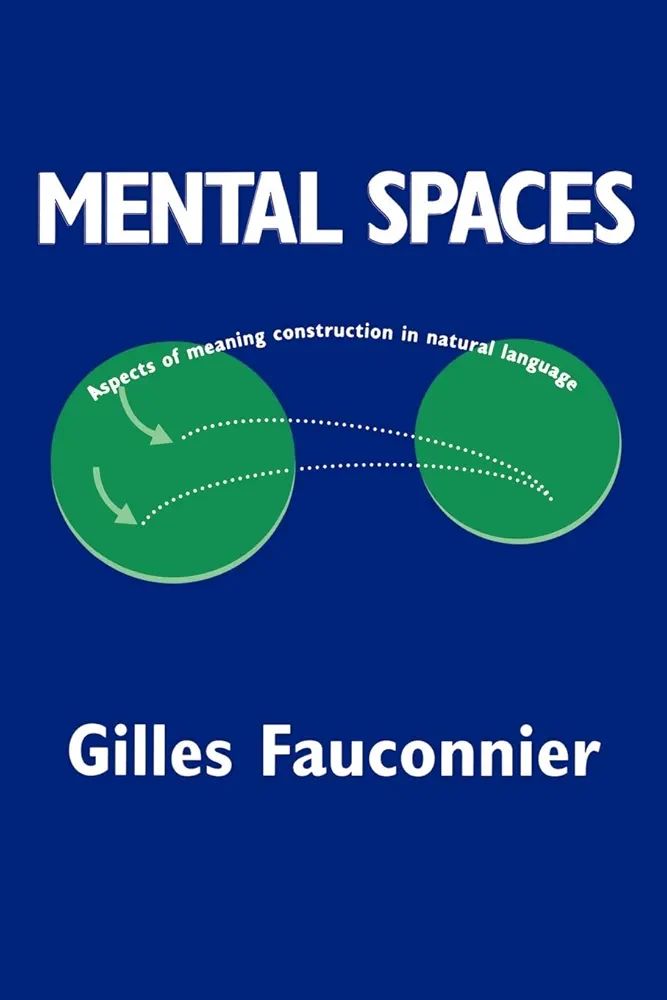لم تعد كثير من الفعاليات الثقافية اليوم تمثّل فعلًا معرفيًا أو ممارسة تنويرية فعلية في خطابها المفترض، بل انزلقت في حالات واسعة إلى ما يمكن تسميته لقاءات اجتماعية مغلّفة بشكل ثقافي، دون غاية محددة تتطلب نقاشا مفتوحا عميقا أو إضافة نوعية، لتتحول الفعالية من مساحة سؤال إلى مناسبة حضور، ومن مشروع وعي إلى طقس اجتماعي، وهو ما وصفه عبد الله العروي بدقة حين تحدث عن “الطقس الفارغ” الذي يحتفظ بالشكل ويفقد المعنى.
في هذا السياق، تغيب الثقافة بوصفها فعلًا نقديًا مستدامًا، وتحضر بوصفها حدثًا عابرًا لا يترك أثرًا معرفيًا يمكن البناء عليه. فيصبح الحضور غاية بحد ذاته، لا وسيلة للاختلاف أو الحوار، ويتراجع النقاش الجاد لصالح المجاملات وتبادل الأدوار. وهو ما ينسجم تمامًا مع تشخيص بيير بورديو للمجال الثقافي حين قال: “حين تهيمن العلاقات الاجتماعية على الإنتاج الثقافي، تفقد الأفكار استقلالها”. عندها تتحول المنصات الثقافية إلى فضاءات علاقات عامة، لا مختبرات أفكار.
أما على مستوى المحتوى، فإن إعادة تدوير الحدث وعنوانه تكشف بوضوح غياب أي فهم لتصور محدد للتنمية الثقافية المستدامة. فالعناوين قد تتبدل، بينما المضامين ثابتة، وكأن الثقافة تدور في حلقة مغلقة لا تراكم فيها ولا تطور. فالتنمية المستدامة، في معناها الثقافي، تفترض تراكم المعرفة، وبناء الأجيال، وفتح مسارات جديدة للتفكير، لا الاكتفاء بإعادة تدوير حدث يملأ فراغ الروزنامة ثم يُنسى بانتهاء التصفيق.
وتتعمق الإشكالية حين تتحول هذه الفعالية إلى آلية لإعادة إنتاج نخبوية مقنّعة؛ إذ تُدار الفعاليات ضمن دوائر ضيقة، يُعاد فيها استدعاء الأسماء ذاتها، ويُقصى الصوت المختلف أو النقدي، في تناقض صريح مع مفهوم الاستدامة الذي يفترض ضخ دماء جديدة في الحقل الثقافي. وقد لخّص غرامشي هذه المعضلة بوضوح حين أشار إلى أن أي ثقافة لا تخلق مثقفيها الجدد محكوم عليها بالتكلّس. لينحصر ذلك في التعامل مع الفعالية بوصفها رقمًا في تقرير شهري أو سنوي، أو مادة إعلامية، أو صورة بروتوكولية، لا بوصفها حلقة ضمن مشروع ثقافي طويل الأمد. فالمؤشرات الكمية كعدد الحضور، التغطية الإعلامية، وكثافة الفعاليات، تطغى على المؤشرات النوعية. لنتساءل: ماذا ستضيف؟ وما الذي تغيّر؟ وما الأثر الذي سيبقى؟ هنا يغيب مفهوم التنمية المستدامة لصالح إدارة الحدث.
من هنا، فإن توصيف الفعاليات الثقافية المعاصرة بأنها مجرد لقاءات اجتماعية ليس موقفًا عدائيًا من الثقافة، بل محاولة لتشخيص أزمة الثقافة العميقة، باستبدال المشروع بالحدث، والعمق بالصورة، والاستدامة باللحظة. وما لم يُعاد الاعتبار للفعالية الثقافية بوصفها مسؤولية معرفية ممتدة، لا مناسبة اجتماعية عابرة، ستظل الثقافة حاضرة في الشكل، مكررة الوجوه. غائبة في الجوهر، وعاجزة عن تحقيق أي معنى تفاعلي للتنمية المستدامة.
د. فهد توفيق الهندال