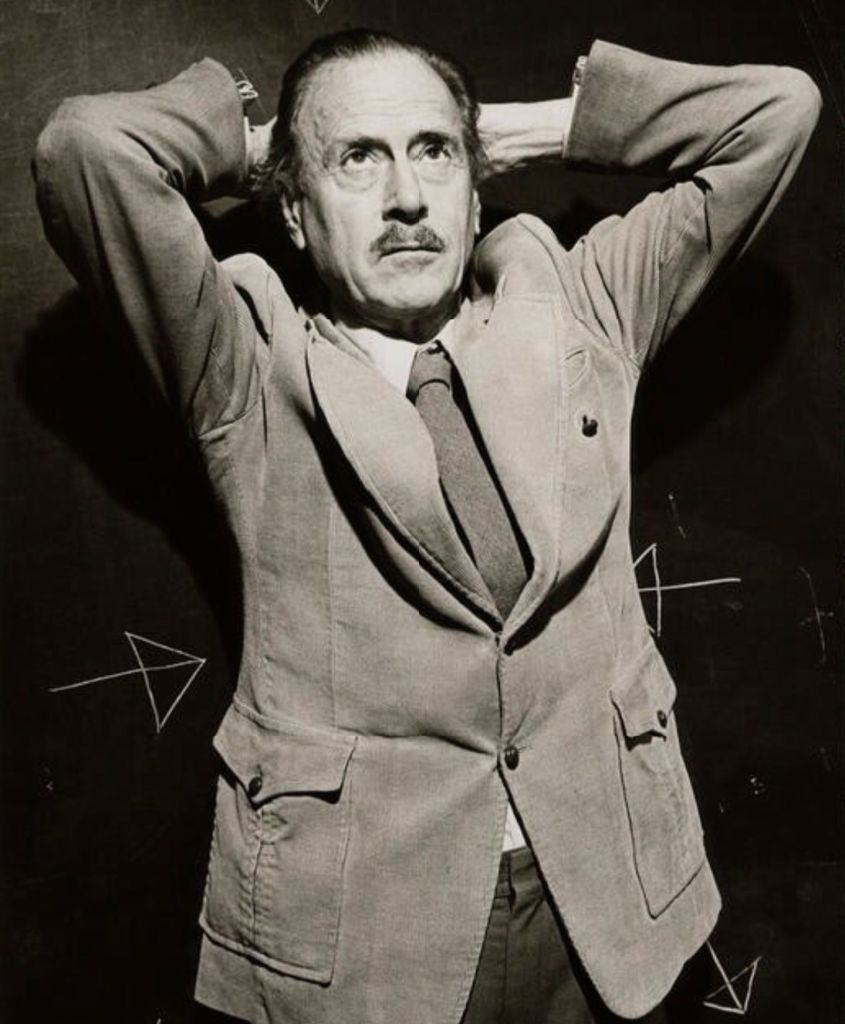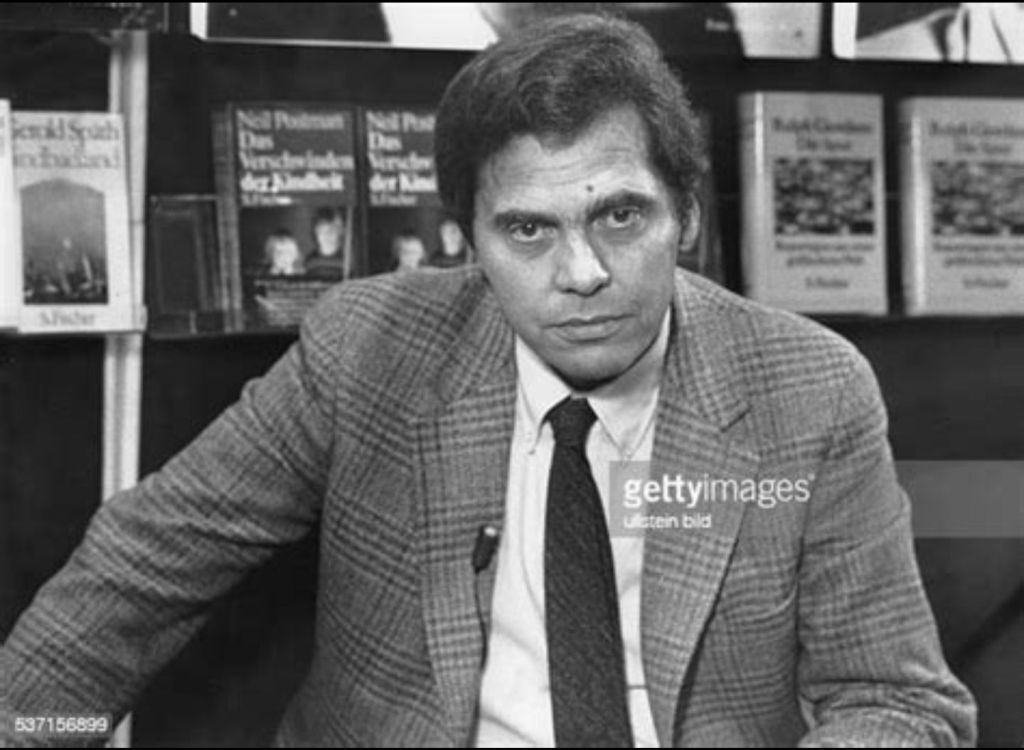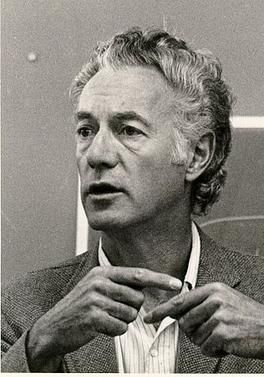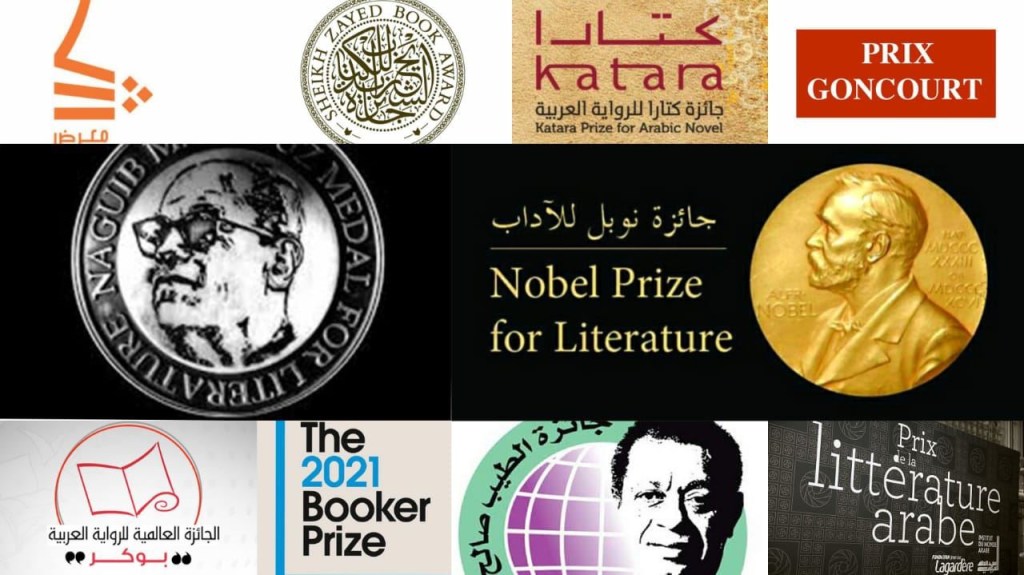هذا السؤال أطلقه أحد ضيوف معرض الكتاب في إحدى دوراته السابقة، عندما تفاجأ بخلو القاعة إلا من بضعة أشخاص، وعشرات الكراسي الشاغرة، وكأن سؤاله جاء نتيجة صدمة وهو الأديب الذي له العشرات من الإصدارات والصيت الشائع بين الأوساط الأدبية والثقافية. فلم يخطر بباله أن يخصص وقتا للموافقة على ضيافته وتقديم محاضرة، فيفاجأ بخلو القاعة!
تكرر هذا السؤال في ندوات مشابهة وإلى اليوم، إذ لا تكمن أزمة الفعاليات الثقافية في ضعف التنظيم أو قلة الدعم، بل في سؤال أكثر جوهرية: لمن تُقام هذه الفعاليات؟
فالمتلقي، بوصفه الغاية الأولى لأي فعل ثقافي، غالبًا ما يُستبعد من عملية التخطيط، ويُستبدل به تصوّر ملتبس ليس موجها لنخبة معرفية ولا لجمهور جماهيري. وبين هذا الالتباس، تفقد الفعاليات قدرتها على الإِثارة، ويتحول الحضور إلى مجرد امتلاء جدول الفعاليات، ليصبح طقسَا شكليَا بلا أثر.
ليس المتلقي الثقافي المعاصر صفحة بيضاء، ولا مستهلكًا سلبيًا. إنه قارئ ومشاهد ومتابع، يقارن بين ما يُقدَّم له في قاعة ثقافية وبين محتوى مفتوح ومتجدد على المنصات الرقمية. لذلك لم يعد يمنح وقته لفعاليات تعيد إنتاج الخطاب نفسه، أو تتكئ على أسماء متكررة بوصفها ضمانًا للحضور. حين يرى المتلقي الوجوه ذاتها، والعناوين ذاتها، يدرك أن التجربة متوقعة، فينسحب قبل أن تبدأ.
عند متابعة التجارب العالمية الناجحة، على سبيل المثال لا للحصر، Hay Festival الذي تأسس عام 1988 في ويلز وهو مهرجان عالمي للأدب والفنون، يربط القراء والكتاب في فعاليات إبداعية. أوEdinburgh International Festival الذي تاسس عام 1947 وهو احتفال سنوي رائد للفنون الأدائية، نجد أن هذه الفعاليات لا تراهن على الأسماء وحدها، بل على تنويع الأصوات، وربط القضايا الثقافية بأسئلة راهنة، وتقديم المحتوى بصيغ حوارية وسردية تشرك المتلقي في صناعة المعنى. كذلك فعلت مؤسسات معنية بالمتاحف والمعارض مثلTate Modern في لندن ، حين حولت زيارة المتحف من فعل مشاهدة صامتة إلى تجربة تفاعلية، تُخاطب الفضول قبل المعرفة المتخصصة.
في المقابل، تعاني كثير من الفعاليات الثقافية العربية من منطق الاستهلاك الذاتي. تتكرر الوجوه نفسها، وتُستعاد العناوين الكبرى من قبيل “الهوية” و“التحولات الثقافية”، بينما يظل المحتوى عامًا ومجردًا، لا يضيف جديدًا ولا يفي بوعد العنوان. هذا الانفصال بين العنوان والمضمون يُنتج خيبة صامتة، ويقوض ثقة المتلقي في الخطاب الثقافي ذاته.
ولا تقل خطورة إقصاء المتلقي داخل الفعالية نفسها، حين يُختزل في دور المستمع الصامت. فالثقافة التي تُلقَى من منصة مرتفعة، بلا مساحة حقيقية للنقاش، تعيد إنتاج علاقة عمودية تجاوزها الزمن. دون أدنى إدراك بأن الانطلاق من سؤال المتلقي لا من مكانة المتحدث هو مفتاح الاستدامة الثقافية!
لذلك، انتبهت بعض الفعاليات الثقافية العربية مؤخرَا لأهمية بناء علاقة مستمرة مع المتلقي، عبر احترام ثقافته، وإشراكه في الحوار، بادرت لتنوع قنوات الثقافة ودمج الأدب بالفنون والسرد الشفهي والحوار المفتوح، واستضافة أصوات جديدة تكسر الرتابة.
فإعادة الاعتبار للمتلقي تعني إعادة تعريف الفعالية الثقافية بوصفها تجربة لا مناسبة، وحوارًا لا محاضرة. فالمتلقي ليس فئة تُستدعى في اللحظة الأخيرة، بل هو نقطة البداية. وحين يُبنى المحتوى انطلاقًا من أسئلته وقلقه المعرفي، وحين تكون العناوين منتجة للثقافة لا استهلاكية، تستعيد الفعاليات الثقافية قدرتها على الإِثارة، وتتحول من أحداث عابرة إلى فضاءات حية للمعنى.
د. فهد توفيق الهندال


Hay festival